أمل ممدوح
عقل هادىء وقلب دافىء” عبارة عرفتها كإحدى توصيات المخرج الروسي ستانسلافسكي لمنهجه، لكني دائما ما كنت أتذكرها حين أراه أو أقرأ له، فهو يبدو دائما مطمئنا هادىء الأعصاب كمن لا يعبأ بشيء، لكن شغوف متوهج أيضا كالعاشق، يشع اعتدادا تبرزه وقفته الشامخة بشكل تلقائي، بقامته القوية الفارهة، مع لغة جسده الواثقة بارتياح، وطريقة إمسكاه بسيجارته الصديقة، بينما يضع يده الأخرى في جيبه أو عند وسطه، دوما بكامل أناقته، بملابس رسمية كنبيل أرستقراطي، بينما تكتشف سريعا بساطته الشديدة وروحه المرحة إذا ما تحادثتما، فهو قادر على إزالة المسافات بود يظهر حتى في صوته رغم اعتدال نبرته، سرعة بديهته وروحه المصرية القريبة تطلان دوما فتزيدان حضوره الطاغي، فهو يداهمك بكاريزما لا تملك إزاءها إلا الالتفات له وحده بين الجموع، ومع ذلك لا تلمح فيه ظلال “الإيجو” وأمراضه، له نظرة هادئة مستغرقة تصاحبها ابتسامة غالبا، مع رشفة عميقة لسيجارته المدللة بتمهل متلذذ كمن معه كل شيء، لتعرف سريعا أن هذه النظرة التي لا تفشي شيئا لم تدع شيئا إلا ورصدته، تبدو في عينيه بدايات ضحكة أو نهايتها، وكأنما يتأمل الحياة بنظرة كاريكاتورية ساخرة تعريها وتجردها من صرامتها، ربما لأنه خاض الكثير من معاركها وخبرها شرقا وغربا وزمنا، وجها لوجه أو من خلال أعداد من الكتب ومشاهدة آلاف من الأفلام، فثمة ظل ساخر في عينيه يعري ما يقابله وما يراه حتى من وجوه، فقد ذكر لزميل ناقد أن رؤيته لأكثر من خمسة آلاف فيلم جعلته يحسن قراءة الوجوه، وحين يتحدث فحديثه غزير المعلومات متدفق بسلاسة، بمنطق عملي منفتح، حاضر الذهن دائما كأنه في حالة جريان دائم أنت عبرت بها…
إنه سمير فريد؛ “عميد النقاد العرب” كما اصطلح على تلقيبه، أو شيخ النقاد السينمائيين العرب، كان ميلاده في ديسمبرعام 1943 في أسرة متوسطة بحي العباسية الذي نشأ وعاش به، حتى انتقل إلى حي الزمالك بعد ذلك، وحتى غادرنا منذ أربع أعوام في إبريل 2017، درس النقد في المعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرج فيه، وله إسهاماته الكبيرة في مجال السينما والنقد السينمائي وإصدارات كثيرة من الكتب الهامة تصل إلى حوالي 50 كتابا، نال الكثير من الجوائز والتكريمات المحلية والعالمية الرفيعة، وله أياديه الكثيرة على مؤسسات ومشاريع خدمت السينما، التي عاش حياته يعشقها ويخلص لها، لن أفرط كثيرا في هذا الجزء النظري الذي تمتلىء به الصفحات.. وسأحاول الاقتراب منه ومن زواياه النقدية والإنسانية من زاويتي الخاصة، ربما لم أخالطه إلا قليلا لكن تلقي الأرواح والعقول تجربة خاصة لكل منا…

محاضرة في ذاكرتي
أذكر أنه رشح لنا في بدايات حديثه مرجعا يراه من أهم مراجع النقد، هو كتاب “النقد الأدبي الحديث” لد. محمد غنيمي هلال، أعرف هذا الكتاب منذ زمن، لكني تعجبت من اختياره عند الحديث عن السينما، لكنه أكمل قائلا أن مناهج النقد واحدة في كل الفنون، ثم تحدث عن المنهج وأنه ينقسم لقسمين كبيرين؛ إما تناول العمل والنظر له من داخله أو ربطه بالظروف الخارجية، والمهم أن تختار بينهما دون تطبيق ميكانيكي، الأمر الذي أتفق فيه معه، حيث هناك أعمال تفرض وضع ظروف العمل الخارجية في الاعتبار لفهم أفضل، قال أيضا أن الناقد يطور نفسه من خلال الممارسة لا النظرية، وخلال هذه الممارسة يكتشف الناقد نفسه، مستدعيا بعدها مقولة “سارتر” بأن “النقد لقاء بين ثلاث حريات؛ حرية الكاتب وصانع العمل والمتلقي”، دون اعتداء أحدهم على الآخر، فهو يوضح لنا حدود الناقد.
ذكر أيضا تعريف الناقد الأمريكي ت. س. إليوت للناقد بأنه (بشكل غير حرفي)”متلق جيد للعمل، وبالتالي قادر على تقييمه، وهو الفرق بينه وبين غيره”، وأضاف أن مهمة الناقد مساعدة القارىء على تلق أفضل، لا ذكر الصواب أو الخطأ، كما أن الناقد يتوجه بنقده إلى المتلقي لا الفنان، وأكد على أن الناقد لا ينبغي أبدا أن يستسلم لطغيان أي شخصية أو فنان.
عادة كان يتخلل حديثه مقولات أدبية أو تاريخية أو من سير ذاتية، مع ذكر نماذج لكتب وكتاب ومخرجين وأفلام من مختلف العالم والأنواع، فأذكر أنه أعطى مثالا في حديثه بفيلم “الأنيميشن” الإيراني “دجاج بالبرقوق”، ومن جمله الملفتة لنا تلك التي كانت حول تحديد الأعمال الأولى بالنقد، فقال أن ذلك يتوقف على تحديد ما إذا كان العمل فيلما، بمعنى أن تعبيره بلغة السينما أم لا، فإن لم يكن فلا يكون فيلما وبالتالي لا داعي لنقده، وهنا أوضح أن السينما هي التي لا يمكن التعبير عنها إلا بلغة السينما، من حركة كاميرا وحجم لقطات وعلاقات بين اللقطات وسيناريو وصوت وغير ذلك. كما أن على الناقد أن ينقد الفيلم كما هو وليس كما يجب أن يكون، ويضيف أن لهذا السبب فإنه يرى أن المخرجين هم أسوأ أنواع المحكمين في العالم، سواء بسبب الغيرة المهنية، أو لوجهة النظر الفنية، فممارسي العمل قد يكونون أسوأ من يقوم بتقييمه.
يطل ارتباطه بجذوره في حقائق أحب أن يؤكد عليها معنا، فقال أن السينما اختراع عربي في أساسه، لافتا النظر أن في جامعة السوربون توجد تماثيل لابن الهيثم وابن سينا وابن خلدون، وأن الأخوين لوميير قد درسا نظريات الحسن ابن الهيثم، ليعود لما قبل العرب..إلى أجداده الفراعنة رابطا آثارهم بالسينما وطبيعة حركة اللقطات، من خلال ضربه المثل بتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، كل عام في يوم مولده، حيث شعاع الشمس (الضوء) يصنع الصورة، رابطا الجينات المصرية القديمة بصناعة السينما في مصرالحديثة، حيث ذكر أن إنتاج مصر في السينما أربعة آلاف فيلما في 100 عام
شعب واثق لكي تكون السينما
ومن أجمل ما قاله في المحاضرة إضافة لكل ما سبق، أن هناك أساسيات ليعرف بلد ما السينما؛ أولها معرفة المسرح، وهو ما أتفق كثيرا فيه مع الأستاذ، فالمسرح نواة الدراما ويؤسس لربط الدراما بالجمهور وقضاياه، ثم يضيف نقطة أخرى هامة توقفت معها كثيرا، وهي “شعب واثق في نفسه”، بحيث يستطيع الفصل بين الواقع والخيال، حيث تعرض السينما وتظهر سلبيات المجتمع ، مما يتطلب جمهورا يثق في نفسه.
كان حواره متدفقا سلسا وموسوعيا..لم يجلس طوال المحاضرة التي كان يلقيها باستمتاع يظهر مدى حبه لهذه المهنة، التي يعتبر من أعطاها مسماها على المستوى العربي، وانتقل بها لمرحلة منهجية علمية بعدما كان النقد الانطباعي وحده السائد، كان حريصا في هذه المحاضرة أن يؤسس مفاهيم وقيم هذه المهنة، حتى لو كانت محاضرة تطوعية لمجموعة من المبتدئين، وها هي تكتب عنها إحدى الحاضرات بعد سنوات من حضورها، فبقيت المحاضرة وإن غادر الأستاذ.

الأكثر من ذلك أنه لم يكن قد ورد بخيالي وقتها، أني سيأتي يوم سأكون المشرفة فيه على كتب للأستاذ سمير فريد، وكم يصعب ذكر اسمه غير مشفوع بكلمة “أستاذ”، فقد رغبت أثناء إدارتي لتحرير سلسلة آفاق السينما التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، في إعادة طبع عدد من الكتب التي لم تنشر في مصر له، ففكرت في سلسلة من عدة أجزاء اصطلح على تسميتها بمجموعة “الاتجاهات”، واقترحتها على د. يحي عزمي رئيس تحرير السلسلة، واتفقنا عليهم مع السيدة “منى غويبة” زوجة أستاذنا الراحل، وكانوا أربعة كتب، أنجزت منهم في مهمتي كتابين حتى وجودي، وبانتظار الكتابين الآخرين، أما الكتابين اللذان صدرا فهما “مخرجون واتجاهات في سينما العالم” و”مخرجون واتجاهات في السينما الأمريكية”، كانت هذه فرصة لتعرفي على السيدة منى، والتي أستطيع كامرأة تمييزها كامرأة محبة، تملأها ذكرى من أحبت وقدرت، وإن كنت من قبل أستطيع أن ألمح طبيعة العلاقة بينهما من بعض صور رأيتها تجمعهما، فالعلاقات الدافئة المتناغمة تتخطى أطر الصور، أستطيع تمييز ما كانته له، وما تكنه له، ليتأكد ذلك في تعاملي معها من أجل الكتابين، وحرصها الكبير على التعاون لإخراج الكتب في أفضل صورة، مهما كلفها الأمر من جهد، وذلك برغم عائدهم المتواضع من مؤسسة حكومية، وكأنها تلقاه عبر هذه المهام من جديد.
مع أجنحة الحالمين بلا روح أسيرة
لم يكن سياسيا وإن كان يهتم بالسياسة، قال عن نفسه أنه “يساري على طريقة جودار”، كان تقدميا ليبراليا، قادرا على كسر الأنماط الذهنية وتبني آراء خارج وعي محيطه تصدمه، يميل لدعم المواهب الجديدة والاتجاهات الفنية الحديثة، متوافقا بذلك مع طبيعة الفن القادر على استباق الواقع بخطوة أو خطوات، يحارب الرجعية ويناصر الحرية، ساعيا دوما لتحرير الفن من سطوة السلطة والدين، فكان يدعو لخروج السينما من عباءة إنتاج الدولة وتوجيهها، كما له مواقفه لتقليص دور الرقابة الفنية وقيود المؤسسات الدينية على الفن، مثل مواقفه مع فيلم “الرسالة” للمخرج مصطفى العقاد، وفيلم “المهاجر” ليوسف شاهين، والذي كان مناصرا لأفلامه عموما رغم الموقف الجماهيري ضدها، كما كان منحازا وداعما للسينما المستقلة مغردا خارج السرب مع “الحالمين”، بحسب تعبير المخرجة هالة لطفي في مقال عنه، فما أكثر ما ناصر المخرجين الجدد والمختلفين، وأفكارهم الجريئة وأفلامهم، وإن لم يرضي ذلك أو يتفق مع جموع السينمائيين، الذين قد يتهمونه أحيانا بالمبالغة في الانتصار لأعمال متواضعة، ورأيي الشخصي أنه كان ميالا لإحداث نوع من الصدمة، والرغبة في تحرير الفن من قبضة الصرامة والقواعد النظرية الجافة، والآراء والأحكام النمطية، بالانتصار لجانبه الإمتاعي وإطلاق جناحيه بحرية، وهو ما لا يتأتى إلا بتحرير صانع العمل وتخفيف وطأة الأحكام عليه، فيميل للبحث عن نقاط التميز في العمل ويحتفي بها، وهو ما يذكرني بأحد التعريفات الفلسفية للنقد بأنه “البحث عن مناطق الجمال في العمل”.
كان قادرا على الاستشراف وطرح نظريات وأطروحات ترصد اتجاهات وظواهر السينما، فهو صاحب مصطلح “الواقعية الجديدة في السينما المصرية”، والتي رصدها في أعمال المخرجين الأربعة؛ عاطف الطيب ومحمد خان وخيري بشارة وداود عبد السيد، وكان متابعا جيدا لكل جديد ميالا للتطور والحداثية، قادرا على القرارات الجريئة وإدخالها عمليا حيز التنفيذ، كتبنيه للتجارب والكيانات السينمائية الناجحة عالميا والمبادرة لتطبيقها محليا، مثل إسهامه في قيام اتحاد نقاد السينما وتأسيس جرائد سينمائية أسبوعية، ومشاركته في تأسيس جمعية نقاد السينما المصريين، والمهرجان القومي للسينما وغير ذلك، فهو كان يعترف بالتأثير الغربي ويأخذ منه المناسب لكنه يرفض “الروح الأسيرة” له بحسب تعبيره.
كتاباته .. عين كاشفة وصديقة
حين تقرأ لسمير فريد لن تبهرك لغة مغزولة، أو تعبيرات أكاديمية صعبة، أو بريق كلمات غير مألوفة تبدو عميقة، أو أسلوب يغازل القارىء ويسعى لإثارته، لن تجد الكثير من النظريات والمصطلحات النقدية والسينمائية والكلمات الأجنبية، بل ستقف كثيرا أمام بساطة أسلوبه القادر على جذبك دون اصطناع واحتياج لما سبق، قادر أن يعبر إليك دون حواجز، في جريان سهل دون خفة، وأن يشبعك دون إثقال، وأن يضيء بسلاسة ما يستحق أن يضاء، دون ميل لإسهاب لا داع له قد يشتتك ويرهقك، فهو حريص على عدم التعالي على القارىء، أو الانعزال عنه في جزر الأوليمب (مقر آلهة الإغريق)، وأيضا على احترامه وعدم الاستهانة به، فيلتزم عادة بالحديث عن العمل نفسه، مع إحالات ومعلومات خارجية وترابطات إن تطلب الأمر، فيضيفها فقط لفهم أشمل وأعمق للعمل، مستطيعا وضع يد القارىء على مفتاح أو مفاتيح قراءة العمل ونقاطه المركزية، بموضوعية وبدون ذاتية، مع لغة راقية منضبطة دون تكلف، بأسلوب شيق به روح حكاءة دون ثرثرة، أو إفراط في سرد قصة العمل، قد يلخص معنى كبيرا في عبارة بسيطة، فمقالاته ثمرة لاتساع الرؤية والتجربة والفهم الدقيق، يحترم أيضا صاحب العمل، ويحترم تجربته وحديثه عنها، سواء اتفق أو اختلف معه أو معها، فلا يلجأ للشخصنة أو التجريح، ولن تجد أثر خلفيات علاقات أو خصومات في حديثه ومواقفه.

المسرح كنقطة أولى
عبر الأستاذ عن أهمية المسرح للسينما كما ذكر في المحاضرة المشار إليها، وربما أكد ذلك في مواقف أخرى، وهو من تخرج في الأساس في معهد الفنون المسرحية، ويتماشى رأيه هذا مع كتابه “شكسبير كاتب السينما” الصادر عام 2002 عن المجلس الأعلى للثقافة، والذي أسند مهمة كتابة مقدمته للناقدة المسرحية القديرة د. نهاد صليحة، التي بشكل ما أجد بينهما بالمناسبة تشابها كبيرا، على اختلاف وسيط تخصصهما؛ فقد عايشت كلا منهما أو على الأقل تعاملت معه، فكلاهما صاحب علم واسع وموسوعي، مسكون بالشغف والعشق الحقيقي لمهنته، كلاهما منفتح على التجارب الجديدة منحاز لها وداعم للموهوبين، وكلاهما دؤوب معطاء حتى آخر لحظة، معتد بذاته بتواضع وبساطة، وهي سمات الكبار بحق.

تقول د. نهاد صليحة في مقدمتها للكتاب، أن الكتاب “يتبنى المنظور الليبرالي تجاه التراث الأدبي، ولكن دون مغالاة أو تطرف، فالكاتب لا يتجاهل النص الأدبي الأم، الذي يتولد منه العمل السينمائي، بل يتبع منهجا قوامه المقارنة الذكية الواعية بين النص الأدبي الشكسبيري، وبين الفيلم السينمائي، ويكشف هذا المنهج الصعب المركب، عن تمرس الناقد السينمائي الكبير ـ سمير فريد ـ بالفن السينمائي في كافة جوانبه وكل عناصره، وهو ما نتوقعه منه، كما يثبت لنا أيضا وهو الجديد المبهج، درايته العميقة بفن المسرح عامة، وبمسرح شكسبير خاصة، فهو يكتب عن الدراما الشكسبيرية وكأنه باحث متخصص في هذا المجال، بل يحللها بعمق لا يتوفر لكثير من المتخصصين”، ثم تشير بانبهار لأهم خاصية تراها في هذا الكتاب، وترى أنها ربما لم يتطرق لها أحد قبل ذلك، وهي تطرق الكاتب لخاصية “المخيلة السينمائية” في أعمال شكسبير المسرحية، ثم تشير لتعبير سمير فريد “كان شكسبير يفكر بلغة السينما”.
مقتطفات من كتاب
لننتقل الآن لتأمل مقتطفات من كتابته، وسأتوقف مع نموذج منها من خلال كتابه “الموجة الجديدة في السينما المصرية”، ولننظر لكم الفقرات الهامة التي يحتويها فقط كتاب واحد من كتبه :
يقول في مقاله عن فيلم “أرض الأحلام” لداوود عبد السيد : “ولكل عمل فني مفتاح يحتاج إلى قدر من الجهد للعثور عليه، فتلقي الفن ليس عملية سلبية تماما، بل إن متعة الفن في تجاوب المتفرج مع العمل الفني، ويكبر العمل كلما زادت قدرته على التقليل من سلبية المتفرج، وجعله يستمتع بإثارة أحاسيسه وأفكاره”
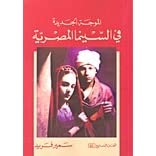
وفي مقطع من مقاله عن فيلم “الرجل الأبيض المتوسط” للمخرج شريف مندور يقول “كل من يخرج فيلما هو مخرج، ولكن ليس كل مخرج مبدعا، وإنما المبدع من يتمكن من الإخراج بأسلوب خاص، الإبداع هو الأسلوب”.
ولا أبسط من هذا الشرح لمفهوم الحداثة، الذي ورد في مقاله عن فيلم “جنة الشياطين” للمخرج أسامة فوزي “الحداثة في السينما أن يكون الفيلم كله مضمون الفيلم، بحيث يستحيل تلخيصه في قصة أدبية، مثل قطعة الموسيقى أو قصيدة الشعر”.
ويروي في بداية مقاله عن فيلم “العودة والعصفور” لهاني لاشين، عن سؤاله حين كان طالبا في السنة الأولى في معهد الفنون المسرحية، لأستاذه محمد مندور الذي كان يدرس له مادة النقد المسرحي؛ “كيف نكون نقادا يا أستاذ ؟”، ليضحك الأستاذ مجيبا “لهذا السبب سميت هذا القسم في المعهد العالي للفنون المسرحية، بقسم الأدب المسرحي وليس قسم النقد، فلا يوجد قسم في العالم كله من شأنه ضمان ولا حتى الحد الأدنى لتخريج ناقد، كما يمكن ضمان ذلك في كلية الطب أو الهندسة أو غيرهما”، ليضيف أستاذه “الناقد يوجد ولا يصنع”، ليستطرد “ولكن هذا لا يعني أن الإلهام والعبقرية كافيان، فالمعرفة أولا، والمعرفة أخيرا للناقد الحق”.
وليس أكثر سلاسة لشرح مفهوم “سينما المؤلف” من حديثه عن المخرج رأفت الميهي، في بداية مقاله عن فيلمه “قليل من الحب.. كثير من العنف”، فيقول “رأفت الميهي نموذج للمؤلف السينمائي في السينما المصرية المعاصرة، ليس لأنه يكتب أفلامه ويخرجها فقط، وإنما أساسا لأنه يعبر من خلال الأفلام عن رؤية خاصة للعالم بأسلوب خاص”.

السينماتيك حلما أخيرا
خمسون عاما تقريبا أمضاها أستاذنا مبحرا في عالم هذا الفن، يعطي بشغف ودأب للسينما التي عشقها، ولمهنة النقد السينمائي التي احترمها وسعى لإعطائها ثقلها، كعلم ذو أسس ومناهج لا مجرد هوى، إلى أن اضطر لإنهاء الرحلة، تاركا وراءه أحلاما تمناها وما زالت لم تتحقق، كإنشاء “سينماتيك” أو أرشيف سينمائي موثق، وإن كان بيته تقريبا يضمه، ففي بيته مكتبة سينمائية كبرى وأرشيف فيلموجرافي دقيق هائل، فلا أقل من تحقيق هذا الحلم والاستفادة من جهده الجاد والهائل عبر السنين، بإنشاء مؤسسة لتوثيق السينما من الممكن أن تحمل إسمه، حفظا لجهده ذاته فيها، كما أتمنى أن يحفظ تراث سمير فريد، ليس كتكريم مستحقا لاسمه، فالأمر يتخطى تكريم الإسم لتكريم مهنة عاش لها وأعطاها هذا الإسم، وسعى لتقديرها وإعطائها مكانتها، فلا يكون الاهتمام فقط بحفظ تراث السينمائيين من صناع السينما، بل إن مهنة الناقد من حافظت على قيمة هذه الصناعة وهذا الفن وحفظته من الانحطاط؛ جديرة في حد ذاتها بالتكريم، وهنا أذكر رأيا هاما لشوبنهاور”إن الناقد هو المؤطر للحاسة الجمالية، وهو مصفاة تقف في وجه المقلدين عديمي القيمة، فالجمهور وفي كل الأحوال يفتقر إلى هذه الحاسة، أي حاسة التمييز بين الجميل والرديء، وفي غياب الناقد، يعمل المندسون في عالم الابداع على خلق اللبس بين ما هو جميل وما هو رديء”، فتحية للصادقين رواد .النور..من رأوا فأرونا.. تحية لك أستاذي سمير فريد
نشر بمجلة الفيلم بالعدد 23 عام 2021

Leave a comment